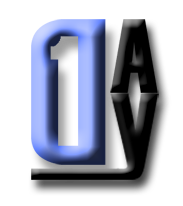بقلم الكاتب: محـمد شـوارب
بيد أني (وأنا متابع مسالك بعض الناس) لم أحترم قط أشخاصاً أحبوا أن يفرضوا أنفسهم على الناس وعلى الدين والثقافة والعلم بألفاظ مغلوطة وإفتراء على الأئمة الأربعة، بل القرآن. فهؤلاء الناس لا أثر لهم في ميادين العلم، ولا ثقة بعقولهم وأفكارهم في شئ طائل يقتحمون ميدان الفكر في عقول الناس، ثم يزعمون بأقاويل من القرآن ويروجون لأنفسهم أنهم أصحاب فكر وعلم ومحدثين عن الله. ويكرهون الأديان الأخرى التي نزلت من السماء. فهل يفيقون هؤلاء من غفلتهم ويثوبون إلى رشدهم؟
لقد أصيبت الأمة بقحط علمي مروّع في أوقاتنا هذه وأيامنا هذه. فهناك خيال مشئوم وحده هو ما وقع في أمتنا المترامية الأطراف! فالأمة التي تأسست ودرست القراءة والعلم والمعرفة غلبت عليها والتي طوق بها البحث والدراسة في كل مجال حتى أخذ عليها الإسراف في بعض نواحيه، قيدها الجمود والتقليد. فأمتنا التي سدت وملئت الكتب في إحدى مدنها وعواصمها مجرى النهر، وتكون منها جسر لكل العابرين، والتي استوعبت فلسفات الدنيا، وكل ما أنتج من الفكر الإنساني إلى عهدها، وصلقته، ونشرته على الدنيا كلها، أمتنا أسدل عليها الليل، فهى لا تعي من العلم الذي قامت به شيئاً يذكر ولا ثمار فكر وعلم وأنارة تجدى، فلا جرم أنها هانت على نفسها وعلى الناس وكان مصيرنا ما نعلم!
ولا شك أن العلم وهب لنا حق الحياة بدل من الموت، ونور بدل من الظلام، وأن مدارسنا الفكرية تركت تراثاً يسحر أولى الألباب بروعته وعناه وذكائه وسنائه. ولكن هؤلاء مربوطون بالغزو الثقافي التي اتسخت به أذهان كثيرة، وتخدمه الآن أقلام وأفكار جريئة، فهل تبقى هذه الفوضى طويلاً؟ أعتقد أن الأمر يحتاج إلى علاج سريع.
أن الأمر في الغزو الثقافي يلقى مقاومة شديدة، وأن محاولات الفتنة وإخراج الناس عن فكرهم المضبوط إلى فكر مغلوط يعد ذلك قصور وخلل في ميادين العلم والثقافة والتربية في عالمنا المترامي الأطراف، وقد ينجح البعض في إفساد القلب وتخليه من العلم واليقين، بيد أن ذلك القلب المصاب يبقى كالبيت الخراب تصفر فيه الريح ولا يحتله ساكن جديد.
لقد لفت نظري في الهجوم والأفكار المغلوطة على القرآن والأئمة الأربعة ونظرت إلى أمتى التعيسة وهي مثقلة بأزماتها وإلى هؤلاء المرتزقة من جملة أقلام وأقوال وأفكار السوء. وأحسب أن المثقفين والدعاة الصادقين، لو تمهد لهم الطريق فإنهم يقدرون على استعادة كل هذه العقول والقلوب الفارغة، وملئها مرة أخرى بالفكر والحق الصحيح والعلم المستنير، يقول أبو الأسود الدؤلي: العلم كنز ودخر لا فناء له، نعم القرين إذا ما صاحب صحبا. فإن العلم كان وما يزال أقرب إلى العقول المواءمة وإلى التجاوب مع أصالة الفكر والتفكير وسلامة الضمير، فإن العلم هو إصلاح عميم الفائدة وعميق الأثر حاسم في ثمراته ودلالاته.
… فكان ولابد من العلماء والدعاة والمثقفين وأصحاب العلم والأساقفة والرهبان والقسس أن ينيروا العقول التي أظلمت، وأن يفجروا أنهار المعرفة والعلم في كل واد وكل دين أنزل من السماء، وأن ينعشوا العقل بالعلم والتدين والفكر السليم، الذي عراه الإغماء، وأن يعيدوا للعلم والبحث مكانهما الأول في صدر التفكير، بدلاً من أن تنجرف العقول وتخلق من نفسها أفكار وأعمال غريبة كالإرهابيين وداعش وغيرها من الجماعات الإرهابية. فإن تجديد أمتنا في ميادين العلم لابد أن تعلو الصيحات بضرورة إعادة الفكر السليم والعلم السليم المتوارث لبعض المتون والشروح وإن انفتح باب الاجتهاد لمواجهة الأحداث الغريبة التي تحدث في أمتنا.
إن هؤلاء أصحاب العلم المغلوط والفكر المنحدر فإن غباواتهم على أسلوب التأليف العلمي فجعله مربد الوجه مرير المذاق، ولست أدري لماذا كثرت أفكار هؤلاء في شروحهم وحواشيهم وتقاريرهم في مجال التفكير والتأليف العلمي والديني. فإذا لم يتفوق هؤلاء العلماء والدعاة في هذا المضمار العلمي والتفكير الخاطئ، فسيكون فشلهم ذريعاً في خدمة الأمة. واللائمة تقع عليهم وحدهم لا على المنصرفين والضائقين.
… لذلك سرني أن أجد بعض من رجال هذا العصر الذين يجمعون بين حسن التصور والتصوير، يسهمون في خدمة العلم والثقافة بأنواع من التأليف السمح القريب والصدق العلمي والذوق العام. فالعلم هو وعاء التقدم الإنساني للأمة ومظهر العاطفة في العقول المفكرة. فهو نعمة الأسلوب المشرق والأداء الساحر.
… ويجب على الأمة أن تدمن في العلم والبحث في خصائص الأشياء وأسرار الأرض والسماء، وأن تكرس لذلك أخصب العقول وأعظم الطاقات حتى يكون هناك ثمار فكر إنساني وعلم في النفس والاجتماع والأخلاق والسياسة والاقتصاد وغيرها. وأن هذه العلوم الإنسانية تخلصت من لوثات الفلسفات القديمة، واعتمدت على المنهج التجريبي وطرق الاستقرار والإحصاء مما يجعلها تصلح وسائل الخدمة العامة في العقول والحياة والأديان.